الرواية بين المعرفة الفلسفية والنظرية
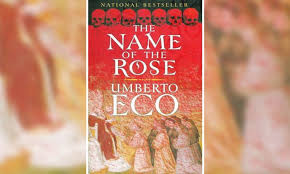
الرواية بين المعرفة الفلسفية والنظرية
عادل ضرغام
ماذا تفعل بنا الرواية؟ سؤال صعب لأن الإجابة عنه تحتاج معرفة ربما ليست متاحة لنقاد الأدب بشكل كبير، فناقد الأدب-ربما تحت تأثير نزعات ونظريات ومناهج- أصبح لا يتوجه في العقود الأخيرة نحو معرفة شمولية تأخذ من كل العلوم، وتتحرك في إطار واسع تكفل لصاحبها الإجابة عن الأسئلة المربكة التي لا تجد بغيتها في شكل محدد ومباشر، ولكنها تحتاج مواجهة من نوع خاص، مواجهة تستقوي بكثير من المعارف والخبرات التي لا تتاح لكثيرين من الذين يظلون لاهثين خلف مناهج مرتبطة بالموضات التي تلحّ علينا كل عقد زمني أو عدد من السنوات.
يبدو الأمر في كثير من الأحيان- أي ارتباطنا الخاص بالرواية في العقود الأخيرة- وثيق الصلة بالتحول في الحياة وأنماطها، وفي الاكتشافات العلمية، فمع هذه الاكتشافات العلمية فقد الشعر- الفن السامي- كثيرا من بريقه، لأن ما يقدمه من اكتشافات وانزياحات عن طريق الخيال أو الغلو في استخدام الخيال الخاص الذي يجمع بين مجالين لا يصحّ الجمع بينهما على المستوى الواقعي، ويجعل هذا الدمج أو التداخل مبرّرا شعريا وفنيا، فقد الكثير من الجدة والطزاجة، لأنها تحقق بشكل أو بآخر، ولهذا نجد الاتجاهات الشعرية المرتبطة بالعادي أو السيري أو السردي بشكل عام لها وجود ملموس إلى حدّ بعيد.
الارتباط بالرواية- في جانب من جوانبه- ارتباط بالعادي والشبيه بالحياة، فخطاب الرواية خطاب مواز للحياة، يعيد تصويرها وتشكيلها في إطار فني، وابتعاد في الوقت ذاته عن خطاب شعري استعاري متعال في صيغه القديمة، لأنه- بالرغم من تعاليه ومحاولة إسدال اختلافه- أصبح ملموسا ومتحققا بالفعل في كثير من جوانب الحياة. الرواية تحقق هذه النمذجة العادية من الالتحام بالبسيط والهش، وإعادة تدويره ومقاربته، وفق بنائها الخاص المنفتح على كل الأشكال الكتابية الأخرى.
فانشداد الرواية إلى الحياة يفكك سلطة الخيال الجامحة في الشعر، ويحرر المتلقي من الثبات الشعري إلى الحركة السردية، فالشعر مقاربة من الثبات، والرواية مقاربة سردية حركية داخل حدود الفضاء المكاني والزماني، تعطي نوعا من الإيهام بالمشابهة، وفي إطار ذلك يشير أورهان باموق في كتابه (الروائي الساذج والحساس) إلى أن القارئ للرواية يتصور نفسه داخل الأحداث، ويشعر أن عالم الرواية أكثر واقعية من الواقع نفسه.
قالرواية بالرغم من خصوصيتها الهجينة في انفتاحها على فنون أخرى، وقدرتها على تطويع الآليات الفنية وتوجيهها نحو منطق بنائي خاص بها، تصنع لنفسها من خلال تطورها المستمر قدرة لافتة على مقاربة الموضوعات والأفكار بشكل مختلف، ينبع من كينونتها المنفتحة على الإضافة، بحيث تستطيع أن تقدم للقارئ شيئا لا يستطيع فن أخر أن يقدمه، فالسبب الوحيد لوجودها في رأي هرمان بروخ فيما نقله ميلان كونديرا في كتابه (فن الرواية) يتمثل في كونها تقول شيئا لا يمكن أن يقوله سواها، فالرواية التي لا تكشف جانبا من الوجود ظلّ مجهولا إلى الآن رواية غير أخلاقية.
وخصوصية الرواية - بوصفها فنا- تتمثل في قدرتها على تقديم عالم مواز، وهذه سمة ليست سهلة، لأنها تفتح بابا لعمليات المشابهة والمغايرة، وتقدم مقترحات وإمكانات للحركة تمثل بدائل مستمرة، وهي في إطار ذلك تقدم معرفة جزئية انطلاقا من صياغة الشخصيات والنماذج البشرية من خلال إطار فني يبعدها عن المباشرة، فأثر هذه الشخصيات والنماذج الروائية كبير، لأنها قُدمت بعناية واهتمام كبيرين، وفي كثير من الأحيان تتحول هذه الشخصيات الروائية إلى نماذج عليا للدلالة على العواطف الإنسانية، لكونها أصبحت علامات دالة يقاس من خلالها مدى الابتعاد أو الاختلاف أو المغايرة مع كل تجل كتابي يضاف إلى تاريخ فن الرواية. وتصبح الشخصيات الروائية ذات حياة وديمومة مستمرين في الكتابات التالية، فهارولد بلوم يشير إلى أن هناك جزئين من ذاتك لن تعرفهما كليا إلا بمقدار ما تستطيع معرفته من دون كيخوته وسانشو بانثا.
الحوار: ظلال المشابهة والمغايرة
تتجلى الرواية في إطار هذه الجزئية بناء تاريخيا ممتدا، تتوالد الشخصيات متناسلة بشكل مختلف، فهي تتشكل-وإن ظلت أسئلتها التجريدية الكبرى بها نوع من الثبات- بالمغايرة وفق سياقات حضارية تسهم في خلخلتها من تجليها في أطر قديمة إلى تجليات آنية، تستمرّ حتى في ظل المغايرة في الإشارة إلى الأيقونة الأولى التي تظل حاضرة بشكل ما. ويمكن في هذا السياق أن نشير إلى شخصيات روائية ظلت حية من خلال التوالد المستمر عبر الأزمنة واللغات.
لا يستطيع أي متأمل أن يغض الطرف عن هذا التسلسل الممتدّ في أثر الشخصيات الروائية، وفاعليتها في القارئ العادي فضلا عن الكاتب الذي يطل إلى هذه الشخصيات بعيني مبدع، يستطيع أن يدرك من خلال وقفته الخاصة طبيعة الشخصيات ووجودها الأيقوني المستمرّ في تجليات كتابية عديدة، سواء بالمشابهة أو التعارض والتباين. فالقارئ يستطيع أن يدرك من خلال التوقف أمام أسماء روائية عربية كبيرة أن هناك حضورا لشخصيات روائية، مثل سمر دياكوف في رواية (الأخوة كارمازوف)، وبلانشو ديبو بطلة رواية (عربة اسمها الرغبة) لتينيسي ويليامز، وشخصية كاف أو راسكولينكوف في رواية (الجريمة والعقاب)، إما باستيراد إطارها العام وسماتها الشخصية، أو باستحضارها بوصفها فكرة أو أيقونة دالة على معنى أو شعور محددين، أو بتفريغها من شحنتها الدلالية المستقرة والعابرة لمحدودية زمنها، وشحنها من خلال المغايرة بدلالة مضادة.
الشخصيات الروائية من خلال هذا التوالد المستمرّ تتحول إلى معان عابرة، وتتأبى على الموت، بل تظل حية منفتحة من خلال إعادة المقاربة من كتّاب آخرين، مما يفضي إلى تجليات عديدة، وتصبح أكثر تأثير وحضورا ونموّا، وتتحوّل في أحيان كثيرة إلى نمط جاهز نقيس من خلاله سلوكنا الفردي بوصفنا من القراء، وسلوك شخصياتنا بوصفنا كتّابا مرة بالمشابهة، ومرة أخرى بالمخالفة والمغايرة.
لكن مدار ومناط اهتمامنا هنا يتمثل في كون هذه الاستمرارية الممتدة في تشكيل الشخصيات وتوالدها وتمددها حية في النصوص الروائية يمثل قيمة فارقة، ويحقق نوعا لافتا من المقروئية، خاصة في ظل تأمل زيادة هذه المقروئية بالرغم من شبح الانسداد الذي يلوح في الأفق. ففي ظل الارتباط بالشخصيات الروائية تتولّد مساحة من المحاورة مع القارئ، إما بالتقليد والسير في اتجاهها وكنفها، واختيار توجهاتها في مقاربة العالم، من بين توجهات عديدة يمكن أن تكون متاحة، أو بالابتعاد عنها إذا كان هناك مغايرة جذرية في الفكر والسلوك، أو الوقوف عندها بوصفها نماذج حيادية، يتمّ اختزانها لتجارب قادمة، ربما لأنها لا تلمس واقعا مدركا بشكل آني أو لحظي.
وهذا التداخل يظلّ حاضرا خاصة في ظل ازدواجية القارئ والكاتب، فحين يتحول القارئ إلى كاتب، تتولّد خصوصية إضافية للوعي بالشخصيات الروائية، وتصبح لديه قدرة على استيلاد إطار نموذجي للشخصيات الفكرية والمذهبية التي تتوالد ذاتيا باستمرار من خلال الأطر العريضة الثابتة في كل تجل في التوجه أو الحركة أو في التشكيل. فحين نقرأ رواية (الطلياني) لشكري المبخوت، أو رواية (مصحف أحمر) لمحمد الغربي عمران، أو (أزمنة من غبار) لناصر عراق، فإننا لا نستطيع- بالرغم من خصوصية الطرح والرؤية في كل رواية على حدة- أن نغفل حدود التشابه بين أبطال الروايات الثلاث من جانب ونماذج البطل التي تمّ تأسيسها في الرواية المصرية في فترة ازدهار اليسار المصري للبطل اليساري الذي يتحرك وفق سياق خاص، حيث تناوشه الأسئلة الوجودية الكبرى مزدانة في شكل تباينات واضحة، مما جعله منقسما على ذاته موزّعا بين إطار مثالي له قداسة، ووجود فعلي كاشف عن العورات والانحناءات والثقوب العديدة داخل هذا التصور المثالي في معاينته لعالم يتحرك بنهم في اتجاه مغاير لقناعاته وخطاباته المعلنة.
فالرواية في تقديمها للنماذج البشرية في لحظة تورطها بسلوكها، وبردّ أفعالها تجاه العالم والحياة، وبتبريرات هذا السلوك انطلاقا من النظم الفكرية والحضارية الفاعلة في تنميط الحركة واختيار التوجه تؤسس لاختيار مطروح. فعرض هذه النماذج البشرية أو الشخصيات بسلوكها يمثل اقتراحات تتماس مع حركة القارئ واختياراته ولو خيالا، وتتيح له هذه الاقتراحات معرفة يختزنها لحظة المرور أو معايشة تجربة مشابهة أو قريبة منها.
فالقراء حين يعاينون شخصيات الروايات تتحرك في الفضاء الروائي يشكلون بالضرورة مساحات للتشابه والاختلاف، وربما يتحركون نحو المختلف والمباين، أكثر من حركتهم نحو المشابه لتكوينهم وخياراتهم، لأن المشابه في إطار جدلية الذات، ووهم صناعة نوع من الاكتمال في الصفات والسمات يصبح أكثر ابتعادا عن الإضافة التي يبحثون عنها، فكثير من القرّاء يظلون مشدودين إلى الشخصيات المباينة لطباعهم وتكوينهم.
فحالة التماهي الصامتة التي يصنعها القارئ مع العمل الروائي تفتح الباب لمساحة واسعة من الاندياح والتداخل بين القارئ والشخصيات المتحركة أمامه التي يعاينها وهو مسترخ في سكونه، ولكن هذا السكون يتباين مع الحركة العقلية أو الذهنية التي تتولّد بفعل القراءة مصحوبة بفرحة الاكتشاف التي تسهم في اختزان الموقف، وتأجيل الفعل لتجارب مشابهة أو موازية قادمة، ويتأسس ذلك المعنى في قول حنا فرانكمان في مقال بعنوان (لماذا نقرأ الروايات؟) (تتميز الرواية بقوة تفتقدها أشكال التواصل الأخرى، وهي القدرة على زجّ القارئ تماما في عقل شخص آخر، وهي بذلك تحفّز على نوع من المزج بين عقلي القارئ والكاتب، وكذلك بين عقلي القارئ والشخصية الروائية).
ويتجلى ذلك المزج بشكل واضح في الكيفية التي يصنع بها الروائي شخصياته في عدم استناده على شخصية محددة يتحرك في إطار تكوينها، وإنما في استناده وتلبسه بنسق عام، يتشكل من محددات متكررة في أنماط وخطابات عديدة، بحيث لا يشعر القارئ أن هناك توجها في حدود شخصية بحد ذاتها، بل يتعداه إلى استيحاء فرادة النمط أو الأنماط بطرائق تشكيلها، والاشتغال عليها من خلال النقل والتحويل والتحوير داخل سياق آخر. تمارس الشخصيات هنا تأثيرا ليس بوصفها شخصيات، وإنما بوصفها أنساقا ونظما فاعلة، يخفي ظهورها المباشر عمليات النقل والتحويل التي يمارسها الكاتب في نقل الفاعلية، وزحزحة الإطار المعرفي من سياق إلى سياق جديد.
فالقارئ حين يتوقف عند روايات عظيمة يستطيع أن يعاين حياة عادية مكللة بعاديتها واشتمالها على رائحة الحياة وتشعباتها وصراعاته المعهودة، ولكن هذا الصخب الحياتي المتولّد من السرد لا ينفي تماما الصيغة أو الصبغة التجريدية أو الفلسفية المشدودة حتما إلى أسئلة ترتبط بوضع الإنسان في الكون. ففي رواية (الحرافيش) لمحفوظ هناك حياة عادية مملوءة بالصراع، ولكن هناك جانبا معرفيا آخر يتولد من خلال التوازي الواضح لولادة الفتوة- كل فتوة- في انشداده من خلال أنساق محددة بولادة الأنبياء على اختلاف وتنوع دينهم، بداية من الوحدة والعزلة في فضاء صحراوي، وانتهاء بالبحث عن العدل.
يتولّد في إطار هذا البناء المتوازي صدع أول محتشم ومكلل بالرمز لحالة التقديس الممتدة، ذلك الرمز الذي تجلى عاريا في (أولاد حارتنا) فأفقدها الكثير من عطاء الرمز ودلالته. فحالة التقديس هذه – من خلال النقل والتحويل- ليست مرتبطة بالأردية والمسوح الدينية، ولكنها يمكن أن ترتبط في ميلادها بسياق آخر مشدود إلى عناصر القوة والسلطة، فالقداسة- وفق النص الروائي وتأويله- سلوك إنساني ينتهجه البشر هلعا من الخوف وطلبا للأمن، وهي- في حد ذاتها- إنسانية بشرية، لا ترتبط بكيان علوي مفارق بمغايرته النوعية، فهي توجد طالما هناك بشر، لديهم ميل لإسدال قداسة على شخص أو أشخاص محددين من خلال تحويل التجريد الفلسفي أو المعرفي إلى واقع مشدود لشخصيات، وهذه ميزة لفن الرواية، بحيث تصبح واقعية وفلسفية في آن، فهي تخلص الفلسفة من التجريد، وتسرّبها- إذا كانت النصوص فارقة- في إطار حياتي مشدود لمواقف وأحداث تتطلب أفعالا تمثل رد فعل ممتد.
نموذج محفوظ الأخير وثيق الصلة بميزة الرواية الأكثر هيمنة ووجودا في النصوص الفارقة، وهي ارتباطها بالمعرفة، وهي لا ترتبط بحشد المعلومات والمعارف وإن كان ذلك نواة أولى، ولكنها المعرفة المرتبطة بالإجابة عن أسئلة تتعلق بالوجود الإنساني في نقصانه الدائم الذي يجعله لا يكف عن محاولة الاكتمال، فالرواية- كما يقول فيصل دراج- (شحاذ يمد يده إلى موائد المعرفة، يسأل التاريخ شيئا، وعلم النفس وعلم الاجتماع، وتاريخ الفن أشياء، فهي على رغم شكلها الفقير تتصرف بالمعارف جميعا، منتهية إلى جوهر الإنسان).
الرواية بين الفلسفي والنظري
المعرفة لا تتقاطع مع المعلومات والحوادث والأيديولوجيا التي يمكن أن نرى حضورها لافتا في النص الروائي، وتقدم بشكل مباشر، بل المعرفة التي تقدمها الرواية مرتبطة بوضع الإنسان أو الأنا أو الذات في مواجهة الواقع، أو هذا العالم الكبير، مستجلية ومفصحة عن بعض إشكالياتها الممتدة التي تتبلور من الوجود الناقص للإنسان، وهي إشكاليات مرتبطة بالأفكار التجريدية والمشاعر الإنسانية، فالشخصيات في حركتها داخل العالم السردي تقدم مقترحات يتماهى معها القارئ.
للمعرفة أو للفكر في الرواية جانبان لا ينفصلان عن بعضهما البعض، الأول منهما يتمثل في ارتباطه بالدلالة وتحديد أساس فكري أو تيمة أو موضوع يتعلق بحركية الفن وتاريخيته في تقاطعه مع الوجود الجدلي للإنسان في العالم، وهذا التقاطع يحيل التيمة في معالجتها أو مقاربتها إلى منحى معرفي أو فلسفي، والأخير يتمثل في وعيه بسياق النظرية والموتيفات والمنطلقات الفنية الأساسية التي تحرّك التوجه العام، في إطار جدل النظريات بين السابق الذاهب للتلاشي والاضمحلال بالتدريج، والآني انشدادا لمنعطفات سياقية حضارية. المعرفة الأولى ضرورية لكل روائي، ولكل نص يتخطى حدود الحكاية الخطية إلى نص تتآزر بنيته لتأطير وتوليد هذا البناء الفكري والمعرفي، وفي ذلك تشير أيريس مردوخ إلى أن هناك إمكانية لتمرير الجانب المعرفي والفلسفي عبر الرواية. فرواية (الغريب) لألبير كامي ليست بعيدة عن أفكار وفلسفة نيتشه العدمية، وحديثه عن الإنسان الأعلى الذي يشعر نتيجة لذلك باغتراب أو نقصان له صفة الديمومة. وفي روايات باولو كويللو، وخاصة روايته (ساحر الصحراء) يتجلى الحضور المعرفي والفلسفي الروحي المرتبط بالإشراق الصوفي للوصول إلى اللانهائي، وذلك من خلال تتبع الإشارات الدالة التي تشير إلى الطريق، والإحساس الباطني.
والقارئ للروايات العربية يمكن أن يلاحظ هذا المنحى المعرفي من خلال الأفكار والرؤى التي يتمّ طرحها بشكل جدلي، ففي بعض روايات نجيب محفوظ يتجلى هذا الحضور المعرفي بشكل كاشف، ففي (الشحاذ)- بعيدا عن درته العالية الحرافيش- يعيد تأسيس السؤال الوجودي والميتافيزيقي، وفي رواية (عزازيل) ليوسف زيدان، وهي رواية لا يمكن فصلها في منحاها المعرفي عن (اسم الوردة) لإيكو هناك اتكاء على تصوير الصراع بين جانبين أو توجهين في المسيحية في القرن الخامس الميلادي، وهو صراع لا يخلو من جدل معرفي فلسفي.
ويمكن أن نضيف في هذا السياق التوجهات الكتابية الآنية المرتبطة بإعادة كتابة السير الغيرية للمتصوفة أو للكتاب المهمين في تراثنا القديم مثل (هذا الأندلسي)، و(العّلّامة) لبن سالم حميش، و(موت صغير) لمحمد حسن علوان، لأن في هذه العودة هناك رؤية حداثية للشخصيات التي يتمّ إعادة كتابة سيرتها، فكأنها كتابة بها نوع من المراجعة، لإدخال هذه الشخصية داخل شبكة علاقات جديدة، تناقش من خلالها جزئيات وثيقة الصلة بالآني، وباللحظة الحضارية التي يعيش في حدودها الكاتب. ففي رواية (العلّامة) على سبيل المثال لا يطلّ ابن خلدون داخل خطاب قديم مستقر، ولكنه يتشكل داخل حدود خطاب روائي مملوء بالترميز لكي تقوم الكتابة بعملية المراجعة للسائد، فتؤسس الرواية للاشتغال على علاقة المثقف بالسلطة في السياق العربي مغربه ومشرقه لتشير إلى أن هناك نسقا ثابتا ما زال فاعلا ومؤثرا، وحتمية أن يظل المثقف- للمحافظة على رؤيته ومشروعه- سائرا على حد رهيف، أو يكون – من خلال نموذج أو نماذج أخرى طرحتها الرواية- على الطرف المقابل فيتعرض لعمليات البطش والتنكيل التي يظل وجودها محسوسا ومتجليا ولافتا على امتداد التاريخ العربي.
فالعودة إلى المتصوفة أو إلى الكتّاب في تراثنا ليست عودة لماض جميل للحنين أو للتعلم، لكنها عودة ترتبط بسؤال معرفي يرتبط بالهوية، فتضعنا جميعا حكاما ومحكومين داخل إطار ثابت لا سبيل لتجاوزه، فالعودة إلى التاريخ نوع من مساءلة الذاكرة التاريخية التي تتمدد خيوطا فاعلة في تاريخنا العربي مشيرة إلى مرتكزات الهوية المتورطة بالثبات بالرغم من مرور العصور والأزمنة. أما في رواية (البيت الأندلسي) لواسيني الأعرج فيأتي الاشتغال على فكرة الهوية من خلال ذم صلابتها وحدودها المائزة والجاهزة من خلال المقارنة بين المخطوطة بوصفها إطارا سرديا التي يشير زمنها إلى حالة من حالات الاستيعاب والانفتاح والمرونة في اكتساب الهوية لإضافات جديدة، والآني المملوء بالتيبس والحدود النهائية القاطعة، تلك الحدود التي تؤسس للإحساس بالمغايرة العرقية والفكرية والثقافية.
والرواية من خلال اشتغالها على هذين الإطارين السرديين تشير إلى أن القلق الهوياتي في إطار السرد الآني التصاعدي ناتج عن إهمال العناصر التي كانت يجب أن تكون حاضرة لتشكيل هوية متصالحة مع التاريخ من خلال استيعاب العناصر المكونة بداية من الدار البسيطة للمتصوف التي تمّ بناء البيت الأندلسي عليها، ومرورا بكل المؤثرات الثقافية والعرقية لجنسيات عديدة، كانت الهوية- لو تجلت بسمة من سمات الاستيعاب القديم- قادرة على جمع هذه التباينات والاختلافات، لكن الحدود القاطعة الكاشفة عن الصلابة لا تعطي مجالا للوعي بالآخر واستيعابه، أو إدخاله في منظومة علاقات متجاوبة، ولكنها تؤسسه دائما مبتعدا وذا وجود مغاير، فلا مجال –والحال تلك- لمعاينة ما لديه من إضافة قد تصبح بالتدريج نسيجا من مكوّن هوياتي جديد.
إن هذا التوجه في الكتابة الروائية انطلاقا من تفعيل مساءلة الذاكرة التاريخية وفق رؤية حداثية أدى إلى وجود مد إبداعي خاص بصيغ تطور الرواية وانزياحها إلى حالة خاصة من الترابط بين اللحظي والتاريخي، وهو توجه لا ينطلق لمعاينة الآني ومعرفته، وإنما لمعاينة التاريخي القديم وفق نظرة حداثية متدثرة ومنطلقة من معرفة آنية، لا تكفّ عن رفد الماضي برؤى جديدة، وهذا أسهم بالتدريج في ارتباط الحادثة التاريخية بجدل خطابات متباينة، فهذا الجدل في الخطابات لا يتأسس إلا في إطار محاولات المعرفة، وجنوح أصحابها إلى محاولات التفسير والتبرير والتأويل.
بداية من عدة عقود تشكل اتجاه خاص في كتابة الرواية، يقوم على البحث، وتجلى ذلك واضحا في نتاج الأكاديميين والمنظرين الذين لهم إسهام في النظرية الأدبية والنقدية، وربما تشكل رواية (اسم الوردة) لإيكو علما مهما على هذا التوجه الكتابي، وقد أثرت تأثيرا كبير على الكتابة الروائية بشكل لافت. فمن يقرأ روايات إمبرتو إيكو يجد فيها توسيعا لكتابته النظرية، فهو في رواياته يحاول أن يفعّل نظريته كاشفا عن بعض حدودها، فالكون أو الوجود يمكن الإمساك به من خلال القص أكثر من النظرية.
فرواية إمبرتو إيكو (جزيرة اليوم السابق)- كما تقول بريجيت إريكسون في مقالها (نظرة رواية إلى نظرية) تشتغل بشكل حرفي على غياب المركز، ففي هذه الرواية ليس هناك مركز، سوى مركز الإنسان، سواء في شخصيته الفردية أو عقليته. ويتجلى غياب المركز- وهي فكرة نظرية مؤسسة في نظريات ما بعد الحداثة- في تعدد البدايات، فليست هناك بداية واحدة، وإنما بدايات ثلاث تهشّم المركزية، وتنفتح على خطابات عديدة. أما في رواية (بندول فوكو) فهناك إلحاح على خطورة بعض أنواع التفسيرات أو التأويل المفرط.
يشير روبرت فيديان في دراسته (بندول فوكو ونص النظرية) إلى أن هناك إشارات تدلّ على أن الرواية بُنيت بشكل خفي حول أفكار (فوكو) التي رفض إيكو وجودها، من خلال نفيه أن تكون روايته متعلقة بهذا الفيلسوف والمنظر الأكثر تأثيرا في القرن العشرين مشيرا إلى كون هذا الالتباس بين فوكو صانع البندول وفوكو المنظر مجرد مزحة سطحية. وقد تنبهت ليندا هوتشيون إلى ذلك حين أشارت إلى الترابط الحتمي في مقالها (حافة السخرية) أن الرواية-أي بندول فوكو- تعدّ تعليقا ساخرا ومستمرا على نظريات ميشيل فوكو، ولهذا يشير روبرت فيديان إلى أنه يمكننا قراءة (فوكو) في عنوان الرواية على أنه كناية عن نظريات ما بعد البنيويين بشكل عام.
فبندول فوكو في ظل هذه النظرة نقد للتأويل المفرط للنص، ونقد لليقين أو الوهم بامتلاك الحقيقة، والتعلق بها، من خلال تصوير الأبطال الثلاثة (بيلبو- وديوتاليفي- وكازابون) في إطار مساحة من الريب بين الخيالي والواقعي، أو بين الحقيقي والزائف، فإمبرتو إيكو من خلال مقتل اثنين من أبطال روايته، وانتظار الثالث لملاحقيه، أي يتحرك نحو مقتله الحتمي، يؤكد على رسالة واضحة، تتمثل في إنه بالرغم من الإيمان بانفتاح الدلالة وعدم محدوديتها، فإن ذلك لا ينفي وجود تأويلات خاطئة، بل على العكس يمكن أن تصبح تأويلات قاتلة.
وقد كان لهذا التوجه أثر في الكتابة الروائية العربية، خاصة لدى هؤلاء الكتاب الذين يؤسسون عن عمد لإنتاج روايات ترتبط بالحديث عن الكتابة الروائية، بوصها ميتا سرد على نحو ما يمكن أن نرى عند هاني عبدالمريد في (عزيزتي سافو)، أو لدى شيرين فتحي في رواية (خيوط ليلى). في رواية (عزيزتي سافو) يتوجه هاني عبدالمريد توجها خاصا في كتابة الرواية الشارحة، أو الميتاقص من خلال السؤال الملح الذي يطالعه القارئ في الصفحة الأولى: كيف تتشكل الرواية؟ أو كيف تكتب الروايات؟ وكأنه يلمح إلى الإطار المعرفي الذي تتحرك في حدوده روايات ما بعد الحداثة من خلال الميتافكشن أو الميتاسرد. وقد ظهرت هذه الآلية في الكتابة الروائية منذ سبعينيات القرن الماضي، فبدلا من الانعكاس في حدود الواقع أو الحياة التي تقدم جزئيات جاهزة للكتابة، ترتبط الكتابة – مع ارتباطها وانشدادها إلى الواقع- بتأمل ذاتها، وتأمل تاريخها داخل حدود النوع، أو داخل حدود الفن بمعناه الواسع.
ويتجلى هذا النمط الكتابي لدى طارق إمام بوصفه آلية فاعلة وخاصة في روايته (ماكيت القاهرة)، ففي كثير من رواياته لا نجده يعتمد على الحكي فقط، ولكنه في كتابته مهموم بنسج كتابة روائية تحتفي بالمعرفي النظري والسردي الحكائي، والمعرفي النظري له تأثير كبير في النظرية النقدية، وله تأثير أقل ظهورا في الكتابة الإبداعية، يقلل من ظهور قصديته الحرفة الفنية، وعدم التوجه إليه بشكل مباشر، وأكثر النظريات بروزا وحضورا في روايته (ماكيت القاهرة) هي نظريات ما بعد الحداثة، خاصة في الجزئيات التي يتناول فيها الحقيقي والزائف، الأصلي والتقليد، الواقعي والخيالي، الماضي والحاضر، والإشارة إلى نظريات سابقة تكفل لكل قسيم من هذه الثنائيات حدودا صلبة مائزة.