من الثبات إلى الحركة وانفتاح الآفاق خارج المنهج لمحمد الشحات
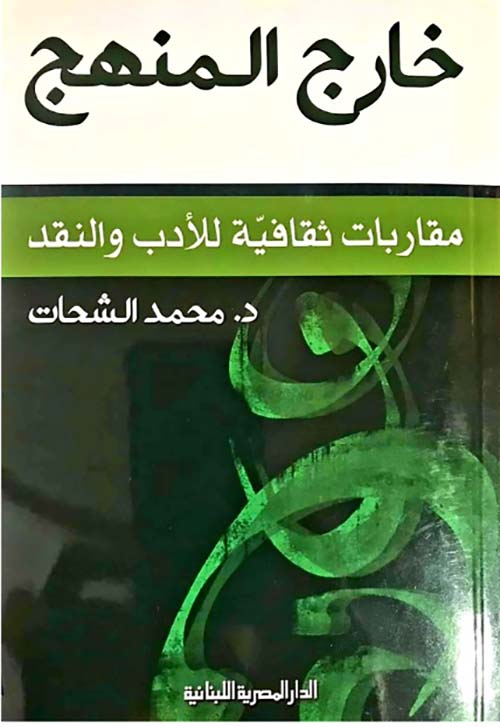
في كتابه (خارج المنهج- مقاربات ثقافية للأدب والنقد) لمحمد الشحات هناك محاولة جادة لتحويل الثقافة إلى جزئية فاعلة، حيث تبدو عنصرا حيويا من عناصر الفن والإدراك، فالثقافة توالد دائم في شكل دوائر متداخلة أو متقاطعة مشكلة في النهاية ملامح أو مناحي معرفية تأخذ شكلها الكلي والجزئي في انفتاحها على السابق وارتباطها بطور الإرجاء الحتمي بالقادم، دون أن يتوقف صاحب الكتاب عندها بالحديث بشكل تراتبي عن تجليات الفكرة، فهو فقط مهموم برصد استمرار تمددها ووجودها فاعلة متخطية حدود المكان والزمان.
يشتبك الكتاب في جزئياته الأولى المحتشدة مع إشكالية - وأظنها لا تزال- مؤرقة لكثيرين من أصحاب الاهتمامات المرتبطة بالنظرية والمنهج، تتمثل هذه الإشكالية في الحدود الزلقة بين المنهج والنظرية في العقود الأخيرة، خاصة في ظل سيادة وهيمنة نظريات ما بعد الحداثة التي حاولت أن تسدّ العيوب أو تجسّر الهوة بين فلسفة البنيوية والمناهج التي سادت في إطارها من جانب، والسياقات الحضارية والمرجعية الثقافية من جانب آخر. في إطار ذلك تلوح في معظم جزئيات الكتاب مناح تتعاظم على قيم الثبات والتحديد والانغلاق والاكتمال، لتحلّ محلها الحركة والتشتت والانفتاح والنقصان فيما يخص مجال الاشتغال والاهتمام وطبيعة المقاربة والتناول بوصف السمات الأخيرة هي السمات المعبرة عن تلك الفترة وما يتجاوب معها من أسس نظرية ومنهجية.
الفكرة الأساسية التي يلحّ عليها الكتاب- وحاول جاهدا صاحبه أن يظلّ وفيا لها- هي التوالد أو التجلي المستمر للمنهج، فكل مقاربة منهجية لمنهج محدد تعني – في الوقت ذاته- ولادة جديدة، تنطلق منها، وتؤسس براحا أو تمددا جزئيا لتحريك أو لإعادة تشغيل منطلقاته، فالمنهج في ظل ذلك التوجه كائن حيّ، وليس ثابتا أو جامدا في أسسه، فالمنهج يمثل حركة دائمة، ويكتسب من هذه الحركة ديمومته، وقدرته على الاستمرار، وتكوين بقايا أو إجراءات أو أطر ذات فاعلية تظل لصيقة حضور إشعاعي في حدود ترسّب الإجراءات المنهجية على المدى الزمني الطويل، فالمنهج لا ينتهي إلى عدم بحلول مناهج أخرى، ولكنه- حتى في لحظات انتهائه واضمحلاله- يترك أشياء لامعة وكاشفة، تشكل مرتكزات قادرة على الاشتغال ولو بشكل جزئي داخل كيان منهجي أكبر يكيّف وجودها، ويعيد توطينها داخل منظومته الفكرية والإجرائية.
وأعتقد أن هذه البقايا مع كل منهج يمكن إدراك ترسباتها، وحلولها في المناهج الجديدة التي ترتبط بالتحديد الصارم للإجراءات، ولكن مع نظريات ما بعد الحداثة وتعددها اللافت للنظر بشكل آني، وليس متتابعا كما هو معهود، أصبحت المناهج التي تتوالد في ظل منطلقاتها زلقة في تلبسها وتداخلها مع النظرية. فالحدود الزلقة في فترة سيادة هذه النظريات لا تطل فاعلة فقط في إطار تلاشي الحدود بين النظرية التي ترتبط بتحديدات تجريدية عامة، والمنهج المشدود لإجراءات، أو الإحساس ببداية ذوبان الحدود الصارمة بين الأجناس لتحل محلها حدود مائعة، وإنما يتجلى بشكل لافت في وجود أسئلة تطرح في كتابات بعض الباحثين تتعلّق بجدوى النظرية أو المنهج. وكلها أسئلة- فيما أعتقد- لا يتم الإجابة عنها في ظل الجدوى أو الوظيفة، لكن من خلال توجه جديد يحاول معاينة التشكل أو التجلي الجديد للمنهج أو النظرية.
من الثبات إلى الحركة وانفتاح الآفاق
تتحوّل إجراءات المنهج في هذا الكتاب بقسميه (قراءات ثقافية) و(هوامش ثقافية)، من كتل صمّاء ساكنة إلى أشكال طيّعة مرنة يمكن إعادة تشكيلها مرة بعد أخرى، فهي لارتباطها بجدل الثقافي تتحوّل إلى ترسبات يمتصها تكوين الناقد دون أن يعي -على نحو دقيق- الكيفية التي تشكلت بها، أو العمليات التفاعلية الداخلية التي قادته إلى الوقوف عند نص يؤشر أو يكوّن ملمحا أو نسقا ثقافيا، فيتوجه نحو مقاربته في شكل مغاير متجدد يخلو من الصلابة أو الثبات مستندا في ذلك إلى جدل النصي والمرجعي الثقافي، فكلاهما- النصي والمرجعي الثقافي- يعدّل ويحور في الآخر، بعيدا عن المقاربات التي تتحول إلى أشكال جامدة يفقد معها النص الكثير من جماله وفتنته، نظرا لعنف الثبات في استخدام المنهج.
فهي مقاربات- نظرا لانطلاقها من فكرة الترسبات المنهجية والثقافية- تحاول التعاظم على الحرفي والإشاري في تفعيل الإجراءات المنهجية، وتستبدلها بمقاربة تذيب هذا الحرفي والإشاري في التحامها بالمناحي المعرفية التي يصنعها ويشكلها العمل الأدبي بوصفها نتاجا ثقافيا منفعلا وفاعلا في الآن نفسه. فالكتاب – باستثناء الجزء النظري الأول الذي يحتوي على قدر كبير من الاحتشاد لتجلية الفكرة- يدور حول شكلين من المقاربة، الأول يرتبط بالقراءة النقدية الموسعة إلى حد ما، وهي قراءة- وفقا لارتباطها بفاعلية الثقافي وحضوره- مشدودة لمعاينة الشبيه والنظير في تجليات وصور سابقة، والأخير يرتبط بالمتابعة النقدية البسيطة التي أسماها (هوامش).
في الشكلين السابقين هناك إصرار على تصوير وتمرير الثقافي، بالرغم من كونه في أحيان قليلة ليس واضحا أو حاضرا بشكل لافت إلا في إطار المقولة التي جعلها منطلقا في قسم من أقسام الكتاب، حيث يعتبر كل فعل كتابي أو قرائي يمثل جزءا من أنساق الثقافة على اختلاف حضورها وتجليها. ففي هذا الكتاب يجد القارئ نفسه أمام مقاربة نقدية بشقيها (القراءة والمتابعة) تمتص آليات المنهج وإجراءاته، فيتحول إلى ممارسة مغايرة تُغيّب من ظهور الإجراءات المنهجية، ولكن تتبقى ترددات لفظية تحيل إلى وجوده وحضوره، صحيح أن بعض هذه الترديدات تأتي مشمولة بالتعمد، لكنها ضرورية على أية حال في إسدال نوع من الانتساب.
يتجلى ذلك واضحا حين نتأمل القسم الخاص الذي يحمل عنوان (هوامش ثقافية)، فبعد القراءة يتكشف للقارئ شيئان: الأول منهما يتمثل في اختياره العنوان الدال والكاشف، لأنه لا يقدم رؤية نقدية مكتملة ومستقرة تمّ تمحيصها، وإنما يثبت في هذا الجزء ما تثيره القراءة للأعمال من حركة للأفكار، وتقليب لمنعطفات الذهن، فالهوامش -والحال تلك- لا تخلو من صواب، ولا تخلو من تعميم يحتاج إلى مراجعة، لأنها لا تعدو أن تكون ملحوظة أو ملحوظات تنطوي على نية المراجعة إما بالإكمال أو الإهمال على حد سواء، وهي آلية تؤكد طبيعة التناول وتحتمّ معاودة المقاربة. أما الأخير فيتمثل في مدّ عروق الاتصال بين النقدي والثقافي، وذلك من خلال ترديد مجموعة من الاصطلاحات التي لها وجود دوري في الكتاب، مثل النسق والنسوي والهامش أو المهمشين والأيديولوجيا وانفتاح النص، وكذلك الحضور الكثيف لأعلام هذا التوجه على المستويين العربي والأجنبي.
يحاول محمد الشحات في هذا الكتاب إثبات ضرورة وحتمية المنهج، ولكن تطبيق هذا المنهج من خلال فعل الممارسة يجب ألا يكون مكبلا من جانب، وألا يكون سبيلا لصناعة الثبات أو التصحر من جانب آخر، فيغدو الالتزام المنهجي تطبيقا آليا لا روح فيه. وقد صنعت لهذا التوجه مساحة من الوجود والحركة طبيعة الإطار الذي يتحرك فيه الكاتب، سواء أكان الإطار ينحو منحى نظريا أو تطبيقيا، فالمتأمل يدرك بعد القراءة أن هناك حيزا أو مساحة تمّ تأسيسها للاشتغال، وأن هناك مصطلحات وإجراءات وثيقة الصلة بحضور الثقافي ونظريات ما بعد الحداثة لها وجود دوري تشير في النهاية إلى قيمة التوجه وقيمة البناء المعرفي الذي يظهر بشكل واضح في مقاربة السرد من منظور الدراسات الثقافية والنقدية.
فتجديد المقاربة المنهجية لا يتجلى إلا بالعمل وإعادة العمل داخل مجال اشتغال له حدود تكفل له التميز، وربما يكون سببا من أسباب الشعور بهذا الاحتشاد الثقافي الذي يلحظه القارئ بوصفه سمة أولى لمنجز محمد الشحات، أن له دائرة اشتغال متنامية، يتوالد بعضها من بعض، ليست متدابرة أو متنافرة، فكل بداية سبيل لانفتاح دوائر أخرى للاشتغال، ينميها بالزحزحة والإضافة، مما ينتج في النهاية عناقيد ودوائر اشتغال متداخلة إلى حد بعيد، ولهذا نجد الاحتشاد من جانب، ومن جانب آخر نجد إحالات إلى عمله أو أعماله السابقة.
مجال الاشتغال الذي يعتمد عليه محمد الشحات في استنبات عكاكيزه بقدر من الخفاء هي مجموعة النظريات التي تعاظمت على التناول الشكلي أو على البنية المغلقة على مركزها في التجلي البنيوي، فالنظريات الخاصة بما بعد الحداثة وأدب ما بعد الاستعمار والنسوية والمهمشين والأقليات كلها نظريات مشدودة للحضاري، وترتبط بالمرجعي وتجلياته في صوره العديدة. وفي ظل هذا الارتباط تتجلى في كتابه عناية خاصة بالتناص وبالطبقات المعرفية المتوالية للأفكار الثقافية، دون إشارة واضحة أو دامغة عليه، ولكنه يتجلى بوصفها الآلية الأكثر حضورا. وعنايته اللافتة بتجليات الفكرة الثقافية على نطاق زمني ممتد لا تعطي كبير اهتمام لاختلاف اللغات والأجناس البشرية المنتجة، فعنايته بصور الفكرة جعلته يشير من طرف خفي إلى التشابهات والتباينات الخاصة بصورة الفكرة التي لا يستطيع الوصول إلى صورة أولى لها أو أصل، في ظل ارتباطه أو دخوله من تشكل آني أو تشكل ماضوي، وفي ظل اعتماده على اكتشافات دريدا الخاصة بانفتاح الطبقة المعرفية الدائم للتشكيل، ولإعادة توليد مناح معرفية جديدة بفعل التكوين الذاتي وفاعلية السياقي والمرجعي.
يعطي الكاتب نفسه مساحة من الحرية لتفعيل الثقافي وأثره في قراءة المنجز الكتابي بأنواعه المختلفة، ولهذا نجده مهموما بتجليات الفكرة دون أن يلزم نفسه بحدود منهجية صارمة تصبح مكبلة في معظم الأحيان، فالفكرة بحركتها وتشكلها داخل الثقافات المختلفة تحيل المنهج إلى حركة دائمة، وترمّم تصحره، ومن ثمّ تعيد تشكيل إجراءاته في كل مقاربة على حدة. ففي دراسته (تمثيلات الديستوبيا في الرواية الجديدة) لا يتوقف بشكل مباشر عند مجال الاشتغال المحدد، وإنما يعيدنا إلى تجليات سابقة لتشكيل الفكرة في إبداعات سابقة، متخطيا حاجز اللغة وحاجز الزمن وحاجز النوع الأدبي، مستندا إلى أن أية فكرة لا تنبت من فراغ، وإنما الإبداع طبقات معرفية متتالية معرضة للحذف والإضافة المستمرة. فنراه يبدأ من (الأرض الخراب) لإليوت للإشارة إلى بوادر الخراب لروحي المعاصر، ثم يتوقف عند بيكيت بوصفه دالا من خلال منجزه على هذا الخراب، وينتقل بعدها إلى طبقات معرفية أخرى، مثل (وليمة لأعشاب البحر) لحيدر حيدر، و(ذاكرة الماء ومحنة الجنون العاري) لواسيني الأعرج، و(حرب الكلب الثانية) لإبراهيم نصر الله.
المهم في مقاربات الكتاب للأعمال الأدبية والنقدية يتمثل في فاعلية الثقافي وحضوره، ومن ثم نجد اهتماما خاصا (بالتناص)، أو تجليات (الثيمة)، فهناك اهتمام بالوقوف عند دوران الفكرة وتنقلاتها من ثقافة إلى ثقافة، ومن سياق إلى سياق، ومن لحظة زمنية إلى أخرى، مثل التوقف عند السردية الميكافيلية بداية من وليم شكسبير وجبرا إبراهيم جبرا ونجيب محفوظ وإميل حبيبي وعبدالرحمن منيف، للإشارة إلى طبقات وتجليات متباينة للفكرة، في إطار توليد سياق جديد من سياق سابق. ويبدو أن القراءة الآنية لعمل ما، ربما تصبح الأساس في التوجه نحو معاينة تجليات سابقة للفكرة، فتجليات الميكافيلي على تنوعها، وتنوع بيئاتها وثقافاتها كانت مدخلا تمّ تصنيعه وتشكيله للدخول إلى رواية (السمسار) لعمرو كمال حمودة، بوصفها حالة سردية تمثيلية لمبدأ الميكافيلي في إطار السلطة وقدرتها في توليد مبدأ المقايضة.
هذا التعدد في تجلية نماذج سابقة أو متوازية للفكرة، له إيجابياته الكاشفة عن الثقافة وتنوعها وفاعليتها، ولكنها من جانب آخر لا تتجلى في الكتابة بشكل كاشف عن طبيعة تجليها، فدائما هناك- في مقاربة بعض النماذج- شعور بالنقصان في تناول الظاهرة أو الثيمة، لأنه تناول لا يتوجه إليها بشكل مباشر، فهو تناول أقرب إلى الإشارة لإيقاظ الفكرة وتنبيه المتلقي إلى دورانها السابق. ففي دراسته (سردية الحلم استراتيجية للتخييل والتأويل) يبدأ من نبوءة سوفوكليس في (أوديب)، وبعدها يحيلنا إلى سورة (الصافات)، وسورة (يوسف)، ثم إلى نص محمود درويش (أنا يوسف يا أبي)، انتهاء بنصي (رأيت فيما يرى النائم) و(النسيان)، لنجيب محفوظ والمخزنجي، وفي كل ذلك يترك القارئ وبه حاجة للإضافة، وكأنه يكتفي بعرض مرايا لصور الفكرة وفق لحظات زمنية متباعدة.
وفي بعض المقاربات الخاصة بمعاينة الفكرة في طبقات سابقة، يشعر القارئ أن هناك وقفات جادة مع أعمال أدبية سابقة، وتتحول مقاربة العمل الحالي الذي يمثل مثيرا أساسيا لتأمل الفكرة إلى مقاربة فيها الكثير من التعجل والمرور السريع. في (رمزية الجدار الجملة الثقافية والثورة) يعود إلى تجليات سابقة لإدخال الجدار في شبكة رموز ثقافية على نحو ما قدم في (حوارات المنفيين) لبريخت، أو في قصة (الجدار) لسارتر، حيث تستند المقاربة إلى فاعلية المنحى الثقافي في توليد وتداخل الآفاق أو الدوائر الدلالية، ثم يختم هذا المنحى المحتشد ليعاين جدار أو جسر مريد البرغوثي في كتابه (رأيت رام الله). يستهلك الباحث الكثير من الجهد في تناوله لعملي بريخت وسارتر، وتأتي –ربما نتيجة لذلك- مقاربته لعمل مريد البرغوثي مشدودة للجاهز، ومسبوقة بإشارات عن المنفى لدي جبرا إبراهيم جبرا، وغسان كنفاني، وإميل حبيبي، وإبراهيم نصر الله وعبدالرحمن منيف.
الانتساب: داخل وخارج المنهج
يبدو هذا التنظير المحتشد في بداية الكتاب محاولة جادة يتوسل بها المؤلف لتسويغ ضمّ هذه الدراسات في سياق واحد، بالرغم من اختلاف طبيعة النظر إليها من حيث طبيعة التناول ومساحة الاهتمام، فهي في منطقه داخل وخارج المنهج في آن، لا تتوسل بالمنهج في صورته النمطية الثابتة، ولكنها تطوّعه كل مرة للتجلي من جديد، أو للتوالد مما يعطي له تواجدا وديمومة مستمرة.
وفي الحقيقة إن تأمل بعض هذه الدراسات قد يعطي دلالة على مشروعية هذا التوجه، خاصة أن مدخل المقاربة الثقافية واسع، وليس له إجراءات قارة، بل يتكشف في النهاية عن تفعيل بعض المقولات من خلال محصول ذاتي محض، ولكن الكثير من الدراسات قد لا يكون كافيا لبناء هذا التصور خاصة في الجزء الأخير (هوامش ثقافية)، لأن القارئ يجد نفسه أمام متابعات لكتب تحاول الاستقواء بأساليب عدة، لإسدال الإيهام وإثبات الانتساب والارتباط بالمنهجية الثقافية والانطلاق منها.
فالكتاب -بالرغم من قدرة الشحات على اختيار العناوين بشكل لافت- لا يتوجه في جزئياته إلى مقاربة الموضوع بشكل مباشر بسبب ضيق المساحة الخاصة بمقال في مجلة أو صحيفة، ففي بعض الأحيان نجد أن العنوان مغر، ولكنه لا يقاربه مقاربة ضافية، مثل عنوان (هل ثمة أسلاف (عرب) للواقعية السحرية؟ صورة العربي في سرديات أمريكا اللاتينية)، فهذا العنوان – من خلال التساؤل الذي وضعه قبل عنوان الكتاب الذي يقاربه-لافت، إلا أن المقاربة لم تقترب منه، ولم تحقق حضورا لافتا، وتوقف الأمر عند حدود الإشارة إلى النماذج، ولفت الانتباه إلى أسماء كتاب غير معروفين بشكل كاف. طريقة التناول هذه لا تروي ظمأ القارئ إلى المعرفة، هناك إشارات، ولكنها لا تصل إلى منحاها الكافي، مثل إضافات ابن جُزي على نص رحلة ابن بطوطة يشير إليها ولا يتوقف عندها، بالرغم من أن الحذف أو الإضافة وثيق الصلة بطبيعة السلطة ودورها في تغيير النص بحذف جزء منه، أو الإضافة إليه، وفي السياق ذاته الإشارة إلى إفادته-أي ابن بطوطة- من المستكشف الإيطالي ماركو بولو.
تستند مقاربة محمد الشحات للأعمال الأدبية والأعمال النقدية، والأفكار التي يتوقف عندها، مستدعيا من خلالها أعمالا أدبية إلى أساليب خاصة للاحتماء وتأجيل المواجهة المباشرة مع النصوص أو الموضوعات. ومقاربته تفاجئ القارئ بداية من آلية التعداد والذكر لعدد من الكتّاب والنقاد أو المنظرين أو حتى النظريات التي يشير إليها الكتاب، ويتوقف عندها. وهذا التعداد أو الذكر يشير في سياقه الإيجابي إلى بنية ثقافية جاهزة ومؤسسة لدى الكاتب يتمّ تطويعها وتقديمها في كل مرة حسب الحاجة بأشكال مختلفة، ولكن إطارها غير الإيجابي يتشكل حين يتحوّل التعداد أو الذكر إلى نسق مهيمن، ويأخذ حيزا مساويا- إن لم يزد- لمتن المقاربة أو الموضوع الأساسي الذي يشكل نقطة الانطلاق. فمحمد الشحات لا يحدثك عن نظرية واحدة، وإنما عن مجموعة نظريات بينها صلات وشيجة، وكذلك في حديثه عن الشعراء لا يحدثك عن الشاعر موضوع الدراسة، ولكنه يحدثك عن عدد كبير من الشعراء، وكأن تعداد النظريات أو الشعراء أو الروايات المترابطة أو المتشابكة في الثيمات يكفل معرفة محيطة، بكل هذا المنتج الأدبي.
إن المقاربة على هذا النحو- حتى لو كانت مقاربة ثقافية- تحدث تغييبا للموضوع بدلا من توضيحه، وتبعده أكثر مما تقربه، ففي مقاربته لموضوع (تمثيلات الديستوبيا في الرواية الجديدة)، نجد أن هناك إصرارا على تناول الأعمال العديدة بشكل كلي إجمالي، وهذا يولد بالضرورة سياقا عاما، ولغة ذات حبكة علمية لافتة، ولكنه لا يولّد إطارا عاما للتمايز والاختلاف. فعلى مدار صفحات قليلة تتوقف الدراسة- بعيدا عن الشعراء أو الكتاب الأجانب الذين تمّ ذكرهم في البداية للإشارة إلى تأصيل ووجود الظاهرة- عند (اللجنة) لصنع الله إبراهيم، و(الخالدية) لمحمد البساطي، و(عطارد) لمحمد ربيع، و(الطابور) لنسمة عبدالعزيز، و(يوتوبيا) لأحمد خالد توفيق، و(نساء الكرنتينا) لنائل الطوخي، و(استخدام الحياة) لأحمد ناجي، و(فتاة الحلوى) لمحمد توفيق.
ربما يكشف هذا التعداد أو التناول الكلي عن طبيعة الدراسات الثقافية المهمومة بظهور الفكرة في أعمال عديدة، ولكن يجب أن يكون هناك وعي خاص لتنضيد نوع من المغايرة بين كل عمل وآخر إلى جانب قدرته الفائقة في تنضيد لغة نقدية لافتة. وهذا قد يشدنا إلى آلية أخرى للاحتماء وهي الاستناد إلى الشبيه والنظير، سواء في الأدب العربي والعالمي، فالمشابهة- أو الإشارة إلى المشابهة- تنمّ عن معرفة الخيوط الدقيقة التي تجمع الأعمال، وتضعها في إطار واحد. فواقعية المخزنجي- وهذا شيء طبيعي- تختلف على حد تعبيره عن واقعية أوتوريه وجوستاف فلوبير وجي دي موباسان وهنريك سيك، كما تختلف عن واقعية إدريس ومحفوظ والشرقاوي، فهذا التعداد على المستويين الأجنبي والعربي يفتح الباب للتعميم ويحتاج حتما إلى مراجعة مستمرة.
في مقاربة محمد الشحات للشعر يطلّ سؤال النوع أو الفن الأدبي، ومدى ارتباطه بنظرية نقدية، وتعبيره عن حدودها حاضرا، وهذا ربما نجد له صدى واضحا في النظريات القديمة، فالنظرية الرومانسية- بالرغم من تسليمنا بوجود رواية رومانسية- كانت تستند إلى فن الشعر، وكذلك النظرية الواقعية- مع تسليمنا بوجود شعر واقعي- تستند إلى فن الرواية، فمع كل نظرية أدبية أو نقدية هناك دائما فن أو نوع تؤسس وجودها من خلاله. وأعتقد أن نظريات ما بعد الحداثة والنقد الثقافي بوجه خاص-حيث تلحّ من خلال الاستناد إلى مقولاته موضوعات مرتبطة بقضايا العرق والنوع والجندر والطبقة والسلطة والهامش والمتن والأقليات- أكثر ارتباطا بالفنون السردية النثرية، بالرغم من الإيمان بمشروعية مقاربة الشعر وفق هذه التصورات والمقولات.
وقد قارب محمد الشحات نماذج شعرية لشعراء عديدين، منهم الفيتوري، وأحمد فؤاد نجم، وأحمد الشهاوي، وفتحي عبدالسميع، ويوسف بزي. ومن بين كل هذه الأشعار يطل شعر الفيتوري- وربما شعر أحمد فؤاد نجم لإحداثه خلخلة في طبيعة المتن والهامش- نموذجا لافتا لتفعيل مقولات النقد الثقافي، نظرا لفكرة الزنوجة في شعره، بالإضافة إلى تشكيل خطابه الشعري لخطاب مضاد لثنائية العبد والسيد.
مقاربة محمد الشحات لشعر الفيتوري ربما تعيد طرح السؤال أو الأسئلة المرتبطة بالتخصص، ونوعية واهتمام الناقد وثقافته، بالإضافة إلى الدوائر المعرفية المتشكلة على نحو متوال نتيجة لداوائر الاهتمام، ومدى نجاعة ذلك في الاهتمام بفن محدد، ويبدو ذلك مشروعا حين نعاين مقارباته للسرد مجال إسهامه الحقيقي، ونقارن ذلك بلغته النقدية وإسهامه في مقاربة الشعر. فمعاينة تطبيقاته على النصوص الشعرية من منظور ثقافي تضعه في دائرة العادي، أو في الدوران في نمط كتابة ومقاربة الآخرين، حيث يمثل الوقوف أمام الاقتباسات وقوفا لا يؤدي إلى نتائج لافتة، ولا يسهم في أدراك الرهافة الحادة في نصوص الفيتوري، بالرغم من جهارة صوته الشعري، وحضور الأنا بشكل واضح.
جاء تناوله لشعر الفيتوري تحت عنوان (مجازات التخوم والاستعارات السوداء) كاشفا عن وعيه بالأقنعة، ثم أردفها بحديث خاص عن تعدد الأصوات وتوليد الدرامية. ينتقل بعد ذلك للحديث عن السمات الشعرية التي تستدعي اللون الأسود بوصفه علامة تراتبية وفق الشائع في مثل هذه الدراسات. ولكن المقاربة الشعرية- وإن كانت تستقوي بالثقافي من خلال الإشارة إلى النماذج الفاعلة مثل (لومومبا)، أو بالزنوجة بوصفها تشكل نسقا ثقافيا أو دليلا تراتبيا تصنيفيا- عادية إلى حد ما، فهي لم تدخل هذا الثقافي في إطار فني، ولم تستنطق هذه البساطة الشعرية للوصول إلى أفق دلالي خاص.
ربما تعود طبيعة التناول لدى محمد الشحات لشعر الفيتوري في جانب كبير منه- في عدم إمساكه إلا بما هو شائع- إلى طبيعة شعر الفيتوري نفسه، حيث تأتي سمة الوضوح أو البساطة فاعلة في تراكيبه، ولكنه وضوح البساطة، والبساطة تختلف- بالضرورة- عن السهولة، ففي بعض نصوصه تنطوي هذه البساطة على موقف إنساني خاص يعيدنا إلى أزمتنا الوجودية. المقاربات في الكتاب تتفاوت طبقا للاحتشاد في كل مقاربة، وطبقا لثقافة الباحث المتجلية مع كل موضوع أو مقاربة، فطبيعة التناول قد تستند إلى مؤسس نقدي سابق قام به، وفي ذلك الإطار تزداد المقاربة ثراء من خلال إعادة النظر، وإعادة المقاربة، حتى لو حدث نمو للموضوع، ودخوله إلى دائرة معرفية جديدة، فالدوائر القديمة سيعاد تشكيلها وفق توجه جديد، ومن هنا تكتسب اللغة النقدية عند محمد الشحات هالة من الدلالات والرموز التي تنمّ عن اكتناز لافت للنظر، ولن يتمكن القارئ لمنجزه من الإلمام بدلالاتها إن لم يكن على وعي بهذا التأسيس السابق.
إن النظرة الإجمالية لهذا الكتاب (خارج المنهج- مقاربات ثقافية للأدب والنقد)- بعيدا عن أي اختلاف في وجهات النظر في بعض المقاربات- تثبت حضورا لافتا وواعيا بتسلسل وتوالد النظريات الأدبية والنقدية وارتباطها بفلسفات تتشابه وتتباين، وبسياقات حضارية مؤثرة، وبالمناهج الأدبية في تشكلها في سياق متكامل ينمي ويكمل بعضها بعضا أو في سياق متدابر ينفي بعضها بعضا، ويجعله- أي المؤلف- نموذجا نقديا قادرا على إنتاج خطاب نقدي مغاير، تتأسس حدوده من الحفر بقوة في كل توجه جديد، ومن الاشتغال بشكل متساوق ومتناظر على النظريات وتنوعها، وعلى النصوص الأدبية وحضورها اللافت التي تؤسس في المنعطفات الكبرى التحولات القارة في النظرية وفي أساليب المقاربة.