مرايا الشعرية والشاعر وثنائية الشكل في مجازفة العارف للشاعر محمد إبراهيم يعقوب
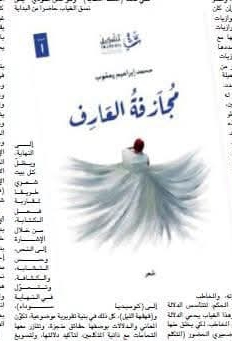
مرايا الشعرية والشاعر وثنائية الشكل في
مجازفة العارف للشاعر محمد إبراهيم يعقوب
عادل ضرغام
في ديوانه (مجازفة العارف) يشكّل محمد إبراهيم يعقوب منحى معرفيا، يرتبط بالكتابة والشعر والشاعر، وبالأشكال الشعرية، وما يتيحه كل شكل من خصوصية فنية في مقاربة الموضوع ذاته، فالنصوص الشعرية وفق مخطط بنائي خاص يكشف عن ارتباط الشعر بالوعي الإنساني، فهي تقدم معرفة بالعالم، وتتجذّر فيه، وتتغيّر صور هذه المعرفة طبقا لحالة الوعي، فكل جزء من أجزاء الديوان الثلاثة يؤسس مرآة لهذه الوعي من جانب، ومن جانب آخر يتعاظم على الشائع فيما يرتبط بالشكل الشعري، فهناك محاولة لإدخال شكلين شعريين داخل إطار من التجاوب والتجاور، وذلك من خلال زحزحة بنيته المستقرة إلى آفاق وثيقة الصلة بالأشكال الأخرى، وكأن هذه النصوص تحقق وظائف إبداعية نافذة خارج المحدّد، مستفيدة في كل ذلك مما تتيحه وتكفله الأشكال الأخرى.
أول شيء يقابلنا يؤسس لهذا التعاظم يتمثل في حضور الإطار المعرفي، من خلال الظواهر الدالة عليه والكاشفة عنه، فالملحقات النصية الموزعة بعناية التي تسبق الأجزاء الثلاثة ليست إلا تكريسا للمعرفة، فالنصوص الشعرية في الديوان- حتى في نصوص الشكل العمودي- لم تعد تعبيرية غنائية، وإنما أصبحت مزدانة برؤية مقصودة لا تأتي عرضا، بقدر وجودها داخل بنية تخطيطية، تكفل لوجودها هيئة وتشكلا مغايرين، وهذا ما كان له أن يتمّ سوى بوجود يكشف عن التجاوب بين الشكلين، والإفادة من سياق تجليه. فالفكري أو المعرفي منطلق أساسي لهذه الشعرية. فهناك كسر لنمطيتها التعبيرية، وهلاميتها الجزئية التي تهدد بنية القصيدة بوصفها بنية متكاملة متضافرة العناصر والبناء والتكوين.
وتناوب القصائد بين الشكلين الشعريين (العمودي والتفعيلي) في الأجزاء الثلاثة، قد يكون به نوع من التعمد، لإثبات الجدارة الفنية والمقدرة الشعرية، خاصة في ظلّ الإحكام اللافت لهذا التناوب. ولكنّ هناك سببا آخر قد تكشف عنه بعض النصوص التي تتخفّف فيها الذات من ثقلها، وتبوح بإشكالياتها الممتدة من بداية الوعي إلى اللحظة الآنية، فيتجلى للقارئ أن هذا التوزع الفني يمثل استجابة للتوزّع التكويني الخاص بالشاعر، فنراه مشدودا إلى خيوط وترابطات تشكل أنساقا موغلة في القدم، ربما أبعد من لحظته الزمنية وسياقه الحضاري، وهذه الأنساق تشكل معادل تكبيل وتنميط وتحديد مسارات، تتباين مع رغبة الشاعر الملحة في التوق والانسلال من هذه القيود والأنساق. وفي ظل هذه التوزّع التكويني للذات جاءت هذه المراوحة في الشكل الشعري، وأفضت إلى مساحة عالية من التسامح والتجاوب بين الشكلين، كاشفة عن خصوصية إبداعية في كل شكل، وإن جاء شكل التفعيلة متأثرا في أحيان قليلة بموجبات الشكل العمودي، في الإحساس باليقين الكتابي والإنجاز الدلالي، ولكن هذا التأثر لم يقض على خصوصية الشكل التفعيلي في اعتماده على بنية التدوير المقطعي من بدايته إلى نهايته في كل النصوص، وما يتجاوب معها من خلخلة لليقين، وانفتاح الدلالة على الإرجاء.
هذه المراوحة أو التناوب بين الشكلين، وما يتيحه كل شكل، جعلا أسئلة الديوان في ارتباطها بالشعر والكتابة وتحولاتها، مشدودة بشكل أساس إلى المنحى المعرفي، في كسر النمط التعبيري الجاهز، وهلاميته الجزئية التي تهدّد بنية القصيدة، بوصفها بنية متكاملة متضافرة العناصر والأجزاء والتكوينات، من خلال التبادلات الخفية بين الشكلين، وانزياح آليات كل شكل نحو الآخر. وهذا يجعلنا ندرك أن جزءا كبيرا من محاولاتنا في زحزحة الأشكال الكتابية عن نمطيتها نابع من هذا التبادل الفني من جانب، ومن جانب آخر نابع من الوعي بالعالم. فإذا كان الوعي مدار اندحار وتسليم، فإن الشكل الكتابي سيأتي مرتبطا بالتسكين الجاهز ومنمّطا بحدوده، وإذا كان الأمر مرتبطا بالوعي الفائق وإدراك شروخ الشكل، وتعرجات وانحرافات الاستقامة المزعومة، فإن في ذلك بداية لثورة تعمل عملها في توجيه الإبداع نحو الحد من سلطة النسق الكتابي المهيمن، وفي التوجيه نحو نسق تحرري منفتح على الأشكال الأخرى، وما تتيحه من آليات فنية. فالوعي الكتابي لا ينفصل عن الوعي بالعالم، وتوزّعه بين الرضوخ والتسليم من جانب، والثورة في إدراكها الخفي لتصدعات الشكل الكتابي من جانب آخر.
بين شكلي اليقين والشك
ثمة قصدية في الفعل الشعري لنصوص الديوان، خاصة إذا استحضرنا العنوان (مجازفة)، وما يحمله من دلالة الفعل غير مأمون الجوانب أو النتائج، ويهدهد قلقه الوصف (العارف)، لأن مجازفة العارف أو العالم أو المدرك لخصوصيات كل شكل يجعله يقترب اقتراب محاذر، كاشفا عن القدرة لا العجز. في نصوص الديوان ثمة ظاهرة لافتة، تتجلى خاصة في النصوص التي تحاول الخروج عن الشكل المستقر، للالتحام بشكل لم تجرّبه، والإفادة من قدرة الشكل على خلق بنية كلية متلاحمة، وإسدال هيمنتها في مقابل التجزئة، واللهاث وراء المعنى الذي يشكل الضربة الدلالية بمفرده، بعيدا عن تساوقها أو عدم تساوقها مع السابق واللاحق، وهي ظاهرة تكاد تشكل وجودا لافتا في الشعر العمودي.
ولكن الشاعر- الشاعر الواعي- بكلّ الأشكال المتجاورة، تتولّد لديه قدرة على الإفادة من محددات ومنطلقات الأشكال الأخرى، وتتسرّب بالتدريج داخل نصوصه. ففي بعض النصوص نجد أن للتدوير وجودا لافتا. والتدوير في الأساس بنية ملتحمة بها الكثير من الانعتاق من المؤسس، فهي دلالة مترابطة تظلّ قيد التشكل المنفتح، وتظلّ مرجأة إلى نقطة الوقف في نهاية المقطع. والتدوير- فوق ما سبق- له دور في القضاء على توازيات البنية في القصيدة العمودية التي تشكل منطقا جاهزا في بحثها عن ضربة المعنى الجاهز المفرد الجزئي، مع التكرار القافوي الذي يشكل حتما وقفة جزئية مستنيمة إلى مستقرها في نهاية البيت. ففي نصه (أسباب مؤجلة لشيء ما سيحدث) نجد أن اعتماد الشكل التفعيلي كان له دور في تحديد الوقفات الإيقاعية، وذلك لاعتماد النص على التدوير في المقطع كاملا، يقول النص في المقطع الأول (نحن اعتياد لا يفسّر- موعد لم يأت بعد- مشيئة تسعى- خرائط لم تكن أبدا مماثلة لما في الأرض من ندم- سؤال واقف في الشمس- تاريخ الخسارات القديمة- وارتباك في الفرح).
من خلال التدوير المشدود إلى المبتدأ (نحن)، وتعدد الإجابة أو الإخبار عنه، في كل سطر شعري، يتشكّل لدى القارئ لهاث لمتابعة الدلالة في طور التكوين المستمرّ، فهي دلالة مرجأة يعاد تقليبها في كل سطر. والدلالة هنا لا تنحو منحى التحديد، بل مرتبطة بالتفلّت، لأن كل سطر شعري- أو كل توجه جديد في معاينة الذات الجمعية في محاولة الإجابة عن سؤال وجودي- يقدّم إضافة تزلزل السابق، وتفتت يقينه، من خلال الإضافة والتمدد. فالنص الشعري يقارب فكرة تتأبى على التحديد، خاصة إذا انطلقت من مقاربة الذات الفردية في التحامها بإطار جمعي، وهي لا تكفّ من خلال هذا التمدد إلى التناقضات الحادة القطبية التي تتحرّك في إطارها الذات بين المتخيل والواقع، حيث يشكل البون الشاسع بينهما مساحة للوقوف.
ففي المقطع الثاني تلحّ النسخ المقترحة بوصفها نسخا متخيلة للذات، من خلال بزوغها في المرايا في مقابل النسخة المشدودة إلى الواقعي واليومي، ولهذا تتجلى الذات داخل هذا التوزّع، فتفقد النسخة أو النسخ المقترحة ألقها، وكذلك تفقد نسخة الواقع هدوءها، يقول النص (نخاف من المضي-جهازنا العصبي منتهب- نعيش رتابة اليومي باسم مقترح).
التدوير- وهو آلية تركيبية وإيقاعية في الآن ذاته- سباحة ضد الوقوف أو الاستقرار، وضد المعنى أو الدلالة المنجزة، هو انفتاح دائم، وكسر لخطية التوازي الجزئي، وإن كان يخلق توازيات من نوع آخر، توازيات متجاوبة لا تتطابق، لأنها تمثل توازيات في الموقعية التي يتغيّر تشكلها مع كل توجه، وتختلف طريقة تمددها وتكوّنها في كل مرة. فالتوازيات في الشعر العمودي لا تخلو من ثبات وراهنية، لكنها مع التفعيلة توازيات منفتحة على التعدد. فالبيت الشعري بشكله القديم له سلطة الإنجاز والاكتمال واليقين، في حين أن التدوير مع السطر الشعري الممتد يخلخل هذه السلطة، ومن خلال التعدد يتولّد الشك في قيمة المنجز والاكتمال.
ففي الجزء الخاص المقتبس من نص (أسباب مؤجلة لشيء ما سيحدث) قد نلمح بعض التوازيات، لكنها توازيات في الموقعية، وقد ندرك شعورا بالإنجاز أو اليقين، ولكن هذا الشعور يجرح بالتعدد، فالتعدد في الإخبار يبذر الشك في المعنى المنجز، لأنه يحمل نفيا لفرادة أو واحدية المقاربة لأي شيء، وهذا التعدد يحطم اليقين الذي يمكن أن نراه واضحا في القصيدة العمودية، والتعدد قد يوجد في النص العمودي، لكنه يفضي إلى التشابه والتطابق، لأن سطوة التكرار وفاعلية القالب المستند إلى التوازي الصيغي والنحوي يقللان من قيمة هذا التعدد، ويحيلانه إلى نوع من التحديد والثبات، أما في نص التفعيلة فالتعدد يؤدي إلى تغييب الشيء، وخروجه- بالرغم من التركيز عليه من جهات عديدة- عن سلطة التحديد والإمساك والقنص.
أما في نصوص الشكل العمودي فالقارئ يشعر باليقين الذي لا تشوبه شائبة في صياغة المعنى، فهذا الشكل يتجلى إطارا للمعنى الذي يحتفي بوجاهته وبجدواه، وكأنه ينبع من الحكمة المستقرة التي تتضمّن نصوصا متطابقة بالتكرار. ففي مثل هذه النصوص، وفي أبيات محددة تصلح نتيجة لأبيات سابقة، أو بداية نصية يتحرّك النص الشعري بعدها لإثبات مشروعية أسطرتها الدلالية يختفي المتكلّم بسطوته، والمخاطب بحضوره المتخيل المشارك في الحكم، لتتأسس الدلالة في وهج الغياب الموضوعي، وهذا الغياب يحمي الدلالة من انحياز المتكلم أو من حضور المخاطب، لكي يخلق منها من خلال الغياب المتحلل من ضميري الحضور (المتكلم والمخاطب)، إيمانا كليا، أو إنجازا دلاليا، يخترق المواضعات والتحديدات الزمنية، يقرّ به الجميع بعيدا عن تحديد فاعلية متكلمة أو مخاطبة.
فالغياب يحيل الحكم إلى نسق عام يتفق عليه الجميع، فحين يقول النص الشعري (العبقرية أن نحاول مرة- في وسعنا ألا نعيق هباء- نحن النهايات التي لا تنتهي- سرّ التعلق أن نعود ظماء- تبقى الغزالة حرّة- ما لم تخف- والحزن أجمل أن يكون غناء)، ندرك أن حضور المتكلمين انفتاح على نسق المتكلم الفردي أو الجمعي، لكنه يظلّ محدودا بوجهة نظر الفئة المختارة، ولهذا في البيت الثالث الذي يشكل الضربة الدلالية الجامعة والمؤسسة لكل ما سبق، نجد حضورا للغياب الذي يغيّب وجهة النظر المرتبطة بالمتكلم أو المتكلمين، ليجعل الحكم الدلالة مرتبطا بالجميع على اختلاف مشاربهم وأزمانهم.
إن حركة الأبيات في كل القصائد العمودية في الديوان- بعيدا عن شكلها وتوزيعها على هيئة الشعر التفعيلي- موزّعة بين أبيات لمتكلم يعطي للنص خصوصية الفرد، وأبيات لغياب مشدودة لبناء أقرب إلى الحكمة في إنجازها وتفردها، وانفتاحها على شمولية الحكم الذي يضم الحاضرين والغائبين. فبيت الحكمة الذي يؤكد المعاني الجزئية السابقة عليه، تتشكّل له هالة أولى من الغياب، وهالة أخرى من الصياغة الموجزة المحكمة، فيلحّ هذا البيت بوصفه مرساة لمجموعة من الأبيات. مع بنية القصيدة العمودية هناك استقرار للمعنى، لأنها تشكل نوعا من الاستقرار الناجز، لا تتسرّب إليه بوادر الشك أو التمدد بسبب الحاجة للتعديل أو الإضافة، وتشكل نتاجا لذات ممتدة خارج التأطير الزمني، مؤمنة بتميزها، وقدرتها على تقديم رؤية مستخلصة من السابق، ومستندة إلى تراث هائل، تدور في آفاقه، ومن ثم تكون القيمة فيه للمعنى الجزئي الذي يتمّ تقريره، وتقديمه إلى المتلقي بوصفه سياقا أعلى، ويتمّ تأكيد هذا المعنى من خلال فاعلية التكرار أو التوازي، أو الختام بالمعنى القفل أو الإغلاق المشدود للحكمة، أو البداية به بوصفه حقيقة دامغة، ويتحرّك النص الشعري العمودي نحو إثبات مشروعيته وجدواه، من خلال معان ودلالات متوالية مشدودة إلى الذات الفردية، أو إلى الذات الجماعية.
ففي نصه (أسئلة الكتابة)- وهو نص عمودي- يظل نسق الغياب حاضرا من البداية إلى النهاية، ويظلّ كل بيت شعري طريقا لمقاربة فعل الكتابة، من خلال الإشارة إلى النص، وحس التشابه، والكثافة، وتتحوّل في النهاية إلى (كوميديا سوداء)، و(قهقهة الليل)، كل ذلك في بنية تقريرية موضوعية، تكوّن المعاني والدلالات بوصفها حقائق منجزة، وتتآزر معها التحامات مع ذاتية المتكلمين، لتأكيد دلالتها، ولتسويغ قيمتها، مثل: (الحب أجمل ما نلوذ به-إذا القلب انهزم)، أو قوله: (نصف التساؤل- ما نريد- وما أراد الله تم)، أو قوله:(هل نحن- إلاما تبقّى- من وجود في العدم). النص في مجمله يؤسس جذوره، سواء في أبيات الدلالة الناجزة بموضوعية الغياب، أو في أبيات الالتحام بالذاتي من خلال السقوط من الانسجام الروحي الذي تصنعه الذات من المتخيل بمراياه العديدة (وهي صورة دائمة الورود في نصوص الديوان)، إلى تشظّي الواقع، فهي موزعة بين عالمين، عالم يحقق انسجامها، وعالم يبعثرها. وربما تكون معاينة البيت الأول والأخير مفتاحا للنص، بواقعيته ومراياه المتخيلة، ففي البيت الأول (الأرض أخطاء ابن آدم- والكتابة- والألم)، وفي البيت الأخير (ناي يفكّر في الغصون- ولا يكف عن الندم). في البيت الأول يلحّ فعل السقوط، بوصفه فقدا لانسجام يحاول العودة إليه، وفي البيت الأخير، يتمّ نقل المعنى إلى صوت الناي، حيث يأتي بوصفه حنينا لوجود سابق، فالشاعر في نزاله مع الواقع وتحوّله من سلطة المثال إلى التجريب، شبيه بالغصن في انسجامه قبل أن يتغرّب ويتحوّل بفعل النار فيصدر أصواته المملوءة بالحنين، فالكتابة في ظل هذا النص نابعة من النقصان والسعي إلى الاكتمال والانسجام.
المنحى المعرفي مرايا الشعرية والشاعر
الكشف عن المنحى المعرفي للديوان ربما يكون ماثلا في العناية بالتصدير الذي جاء مع كل قسم من أقسام الديوان الثلاثة، وفي عنوان الديوان والإهداء، ولكن الوقوف أمام تصدير الأجزاء الثلاثة ربما يكون أكثر فاعلية، لأنها مأخوذة بقصدية من كتاب (المواقف والمخاطبات للنفرّي)، وهي تشكل مواقف وحالات متباينة، بين قسيمين لا ينفصلان انفصالا تاما، ولا يتوحدان توحّدا نهائيا. وكتاب النفرّي بوصفه كتابا في التصوّف، له دور في إسدال نوع من القداسة على الشاعر، وعلى منجزه الشعري، أو على عمليات التطابق والصعود والتوحّد بين الإنسان والظل أو الشاعر، وأثر ذلك في اللغة الشعرية في لحظتي التوحّد والانفصال.
ففي التصدير الأول للجزء الأول (قلق إنساني)، حين يقول (وقال لي أنت معنى الكون كله)، ندرك طبيعة البداية وانفتاح القسيمين، فهذه البداية- وإن كانت قائمة على اصطفاء واختيار- تكفل لكل قسيم حدوده، فالإنسان تمّ اختياره، لكنه لا يزال في حدود الوجود البشري المحدد، ولم يفض ذلك إلى توحّد مع الظل أو الشاعر. أما في تصدير الجزء الثاني (فناء طوعي)، فنراه يقول (وقال لي إذا كنت لي، فأنت بي، وإذا كنت بي فأنت لك)، وهذا التصدير- بالرغم من كشفه عن التوحّد والفناء- يظلّ توحّدا وفناء زمنيا، أي يعتوره ما يعتور الكائنات والبشر من تغيّر وتبدّل، ففي ظل هذا التوحّد هناك بداية وذروة وانتهاء، وتفكك وانفصال، وحسرة وتوجّع، وعودة للانتباه والذاكرة، وكلها جزئيات في قسيمها الأخير كاشفة عن غياب الانسجام، وكأن الصحو الذي يطلّ بعد الانتهاء من فعل الكتابة شبيه بالسقوط من الجنة، وما تكفله من ديمومة وانفتاح على اللانهائي، وخروج على محدودية الزمن لمعانقة الأبدي.
وفي التصدير الثالث (انكشاف ماثل) ينقل التصدير قول النفرّي (وقال لي غششتك إن دللتك على سواي)، وهو تصدير يؤسس للحالة أو التجلي الثالث الممتد، وهو تجلّ مغاير للسابق في شيئين: الأول في الفناء الكلي الدائم، وهو فناء يرتبط بالرؤية وزاوية المقاربة حين يتعلٌق الأمر بالكتابة. والأخير- وهو نابع من الأول- يتمثل في ذوبان جزئيات من كل قسيم منهما (الإنسان والشاعر)، وبعد الفقد الذي يصيبهما، تتولّد حالة من الوحدة والفناء بينهما، ناتجة عن تحويرات وتعديلات وتنازلات في كل قسيم، حتى يستقيم التجاوب، ويقلّ التنافر الذي قد نلمح وجودا له في المرحلة الثانية، فقد تحوّل الفناء الطوعي الجزئي الذي يؤدي إلى عبور النهر أكثر من مرّة إلى فناء وانكشاف دائم للرؤية، يقلّم في تكوينات الإنسان والظل في آن.
وإذا كانت التصديرات تؤسس للمنحى المعرفي، وذلك من خلال نقل حالة الصوفي والمريد، إلى نسق الشاعر والإنسان، فإن هناك نصوصا جاءت كاشفة عن عنايتها بالاشتغال على تلك الثنائية، في توزّعه- أي الإنسان- بين متخيل نموذجي وواقعي، مما يفتح الباب لظهور صراعات داخلية مكتومة ومنطوية في الغائر العميق، ومعاينة خسارات تتولّد بفعل الهزائم، والتوزع بين ما يعاينه خيالا وما يلمسه واقعا. ففي نصه (حالة التباس) يأتي تصوير الشاعر لافتا من خلال تقنية الغياب والتمثيل، فيسدل عليه صورة مملوءة بالتناقض، لكنها غير مقيسة إلى شبيه أو نظير، فهي صورة لا تقنع أو تتزيا بالجاهز، وهي - بالرغم من ذلك نظرا لسطوة القالب- تظلّ معاني مفردة مع كل بيت، وتعاني- بالرغم من وجاهتها- نوعا من الاستناد على التوازيات الجاهزة، يجمع بينها منحى معرفي عام، ويقلل من حدة الواحدية والانفصال.
يتشكل فضاء الكتابة الشعرية في بعض النصوص في إطار فاعلية الرصد والتمثيل، في سياق أفق الاندماج والتداخل بين الإنسان والشاعر، وربما يكشف عنوان الجزء الثاني (فناء طوعي) عن مشروعية ذلك الفهم والتلقي، وتكشف بعض عناوين القصائد عن تجذّر هذا المنحى، مثل (أنوثة تحنو إذا انفرطت)، و(في التودد لمجازاتها). حيث يتأسس هذا الاندماج أو التداخل بين الإنسان والشاعر بوصفه فعلا من أفعال الفناء، وذوبان الحدود، فنرى النص يشير إلى لملمة اللغة الخفيفة من معاجم كعبها العالي، فيخامر المتلقي بعد وقوفه أمام هذه الصورة- وصور أخرى بالضرورة- أن المرأة من خلال الفعل الإيروسي المقدّم في النص ليست امرأة من لحم ودم، لكنها الخاطرة الشعرية في فتنتها وسموقها وتعاليها وتفلّتها.
ويتأكد ذلك التوجه في التلقي من خلال فعل العودة إلى الذات والإنسان بعيدا عن الفناء الجزئي لحظة الكتابة والتوحد والفناء في مطاردة الخاطرة الشعرية والإمساك بها، فتلحّ الذكرى- وهي مؤشر إفاقة وإعطاء كل قسيم حدوده- كاشفة عن بوادر الانفصال (لم يتذكّرا من تاريخ العلاقة غير جرح نازف-وتر يشدهما إلى جهتين صائبتين- لم يقفا على خطأ يبرّر ما تفتت في التفاتهما الأخير- تمسكا بالصمت- أسئلة النهاية مرة جدا- وفي اللغة انتباه موجع يصحو إذا انكشف السؤال). ربما كانت هناك كلمات محددة كاشفة عن بؤس الانفصال أو الانتهاء، وهي على الترتيب الذكرى، واللغة المنتبهة (اللغة حين تصبح عادية تواصلية خالية من مسّ الشعر شبيهة الصوفي الذي عاد من الوصل مع المتعالي)، ومرارة أسئلة النهاية، لأنها في تجاوبها، تفتح الإطار الصوري لانتهاء الحالة الإبداعية الشبيهة بانتهاء الفناء الصوفي، وفناء العاشق في معشوقه، حيث الحالة العادية التي تفقد فيها اللغة وحيها الشعري، ووجودها المفارق لخطية العادي التواصلي. فالكتابة إبحار ووصول، تحليق وسكون، ولهذا نجد في النص التالي قوله (أغتسل في نهرها مرتين) إشارة إلى تكرار حالتي اندماج وانفصال الصوفي والعاشق والشاعر.
وإذا كانت الخاطرة الشعرية في النص السابق تظلّ بتمامها واكتمالها وفتنتها، حتى بعد التعبير عنها، فإنها في نص (في التودد لمجازاتها) تأتي محمية بالرمز الأنثوي، وموصوفة بصفات تكشف لها التميّز والتعالي والتأبي. ويستمرّ النمط ذاته في نصوص، مثل (لوعة شرقية)، و(عملية قلب مفتوح)، و(من أجل ما لا أستحق)، حيث يشكل الشعر أو الخاطرة الشعرية نسقا علويا يقترب منه ويلتحم به الإنسان ويفارقه. فالكتابة توحّد بهذا النسق العلوي الذي يولّد البصيرة (تناهيت- أضلعي فوضى- وما رضيت- سمعت ما تفعل الفوضى وأبصرت)، ويصبح الإبداع الشعري في ظلّ ذلك تفسيرا لهذا التوحّد مع اللغز العلوي الشفيف، وتتحوّل الذات في ظل التوحدات أو الاندماجات على مسافات متباعدة إلى شخص يشبه الإنسان، ولا يشبهه في آن، يقول في قصيدة (لعنة المسعى) (في آخر المرآة- شخص- ربما يحنو عليك- وليس يشبه شخصك).
وفي قصائد الديوان هناك تأسيس لمنحى معرفي، يؤسس من خلالها فهما لمراحل تشكل الشاعر، وللشعر والكتابة. فالكتابة وما يتعلق بها من ارتهانات نحو القديم، ومحاولة التملص منه والتوق للخروج هم أساسي في الديوان. ففي نص (استدراكات على سيرة الظل) هناك ارتداد لمعاينة المغايرة وفعل التجهيز للاختيار من البداية، فالشاعر في النصوص تأسيس مغاير، وحضور لافت في سياقه الزمني، تمهّد الحياة لقدومه، ويتمّ تشكيله من حوادثها وخيباتها وهزائمها، ومن المراقبة للآخر القريب والبعيد. ففي النص هناك مراقبة للأم والأب، وهي ليست مقاربة عادية، بل مقاربة تستشرف الباطني والحقيقي داخل كل منهما.
هذا الوعي اللافت من البداية في وصوله للباطني الخفي من بداية الطفولة يشكل عملية التجهيز التي تتجلى في بوح شعري في مراحل تالية. فالشعر- مثل النبوة- تسبقه عمليات تجهيز واختيار داخل سياقات خاصة، تكشف عن وعي له قدرة على النفاذ إلى الهامشي الحقيقي الخفي، فيحيله متنا، ولهذا كشف النص الشعري عن ذلك في السطر الأخير (الشعر كان حفيا واصطفاه). وتلحّ الجزئيات الخاصة بالأسئلة الشعرية، والتصورات الشعرية للتخلص من الأنساق أو الذوبان في حضور سلطتها، فالشعر في هذا الديوان يتشكل في حدود هذا الصراع. ففي ختام النص الشعري (لكن العالم لا يفنى) هناك إلحاح على هذا الفهم (لكن العالم لا يفنى- سيظلّ النسخ- سيظلّ النسخ- سيظلّ النسخ)، فالسابق حاضر في الآني الشعري، والتكرار على هذا النحو يكشف عن قناعة كاملة بهذا الحضور، فهو (الصوت الداكن)، و (اللغة المنسية) الذي يظل حاضرا محافظا على وجوده وصلابته، وإن تغيّر شكله.
والنص الشعري إذا كان يشير إلى أن التناسخ هو قدر أي نصّ، وهويته الأساسية في كل كتابة، فهو يشير-ربما بدون وعي- إلى توالد الأفكار ذاتيا من بعضها البعض، خاصة إذا كان هناك يقين يجعل أسئلة الفن أو الشعر من بدء الخليقة واحدة، فهي أبنية دائمة حاضرة، في شكل إجابات عن أسئلة الفن، لكنها إجابات ليست نهائية، فهي مشمولة بالإرجاء الذي تتشكل حدوده بالنقصان والسعي نحو الاكتمال. والشعرية لدى الشاعر الواحد لا تتجلى على هيئة واحدة، بل على هيئة مراحل تكشف عنها مرايا الشعر والشاعر، وهي مرايا متجاورة، لها جذر واقعي تقوم بتقديم انعكاسات عديدة لتطور نصه الشعري ووعيه، ولهذا تشير بعض النصوص الشعرية إلى كثافة التعدد داخل الواحد الفرد، فمرايا الشعرية في نص (الغريب) عديدة، بالرغم من كونها تعكس وجودا لفرد واحد، مملوء بالإضافات والصور العديدة للمتخيل الذاتي الذي يأخذ شكلا مختلفا في كل مرحلة، وفي تحولاته لا يطمس المراحل السابقة، فحين يقول الشاعر في نص الغريب (على المرآة آخر-كيف أحصي الذين عبرتهم- من غير عدّ) ندرك أن الصورة لتي تعكسها المرآة ليست واقعية فيزيائية، وإنما متخيلة وعديدة، لأنها منفتحة على كثافة السابق وشعريته، وانفتاحه على النموذجي الذي تخلقه الذات، ويضعنا النص الشعري (فردية تعلل نفسها) وجها لوجه مع هذا التصور الكاشف عن التصوّر المتعدد المختزن للظل في مقابل واقعية الإنسان (أنا ما انتهى منّي إليّ- ولم أكن سواي- ولكني- مرايا طبائعي).